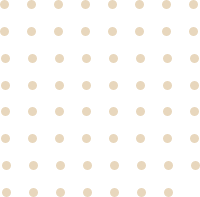News Details

النهج الكويتي للتملك العقاري... رؤية تشريعية متوازنة
لا شك أن مسألة تملك الأجانب للعقارات لم تعد مسألة فنية محصورة في إطار قانوني ضيق، بل أصبحت من القضايا الستراتيجية التي تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية، والاعتبارات السيادية، والاحتياجات المجتمعية، بل وتمتد لتشمل الأمن الاجتماعي والعمراني.
وبينما تسارعت بعض الدول الخليجية إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب للتملك المباشر، في محاولة لتعزيز جاذبية الاستثمار وتنشيط الأسواق العقارية، اختارت الكويت نهجًا مغايرًا، يقوم على التنظيم الدقيق، والضبط التشريعي، والتدرج المسؤول، وهو ما أراه – من واقع خبرتي ومتابعتي للشأن العقاري – توجهًا رشيدًا وقرارًا سياديًا يُحترم ويُبنى عليه.
وينطلق المشرّع الكويتي من قاعدة واضحة ومباشرة مفادها:
"تملك العقارات في الكويت حق مقصور على المواطنين، ويُحظر على غير الكويتيين تملكها، ما لم يرد نص أو مرسوم بخلاف ذلك".
هذا الحظر لا يُفهم باعتباره رفضًا للاستثمار أو انغلاقًا عن العالم الخارجي، بل هو تقييد تشريعي مشروع استند إلى ضرورات الأمن القومي، العدالة الاجتماعية، محدودية الأراضي الصالحة للتملك وارتفاع الطلب المحلي وهي مبررات ذات طبيعة سيادية بامتياز.
وقد ورد الحظر العام في المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، وأعيد تأكيده بتعديلات لاحقة، مع فتح باب الاستثناءات وفق ضوابط صارمة، أبرزها:
1- الخليجيون: يُعاملون معاملة الكويتيين وفق قانون خاص، دون شرط المعاملة بالمثل منذ تعديل 2004.
2- الاجانب: لهم حق التملك لأغراض البعثات الديبلوماسية، بموافقة مجلس الوزراء، وضمن حدود المساحة.
3-العرب: يمكنهم التملك للسكن الخاص بشروط تشمل الإقامة الطويلة، وعدم ملكية أخرى، والموافقة الوزارية.
4- الشركات: لا يجوز لها التملك إذا كان بها شريك غير كويتي، باستثناءات محددة كالشركات المدرجة والمصارف العقارية.
5- أبناء الكويتية: بعد تعديل 2025، أصبح لهم الحق في الاحتفاظ بالعقار الموروث من الأم دون إلزام ببيعه، وهو تعديل إنساني عادل.
فالكويت، بموقفها الحالي، لا ترفض الانفتاح العقاري، لكنها تختار أدواتها بعناية، وفق ما تراه محققًا لمصلحتها العليا.
فالتملك العقاري للأجانب في الكويت لا يتم إلابمرسوم ولأغراض لا تتصل بالمضاربة أو الاحتكار وشروط فنية وقانونية صارمة.
وحتى حينما تم تعديل القانون في 2025 لتوسيع نطاق التملك لم يُفتح الباب على مصراعيه، بل قُيّد التملك بأغراض الاستخدام الفعلي (السكن أو نشاط اقتصادي).ومنع توزيع العقارات على غير الكويتيين في الشركات المختلطة، وقُصرت استفادتهم على العوائد النقدية.
هذا التنظيم يعكس سيادة تشريعية واعية لا تخضع للتيارات العابرة، بل تُوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية الموارد العقارية المحدودة.
ومن هذا المنطلق، أجد من المهم الإشادة بالتجارب الخليجية التي حققت نجاحات ضمن بيئاتها المختلفة، وفي الوقت ذاته أثمّن النهج الكويتي الذي جاء متناغمًا مع معطياته الواقعية وأولوياته الستراتيجية